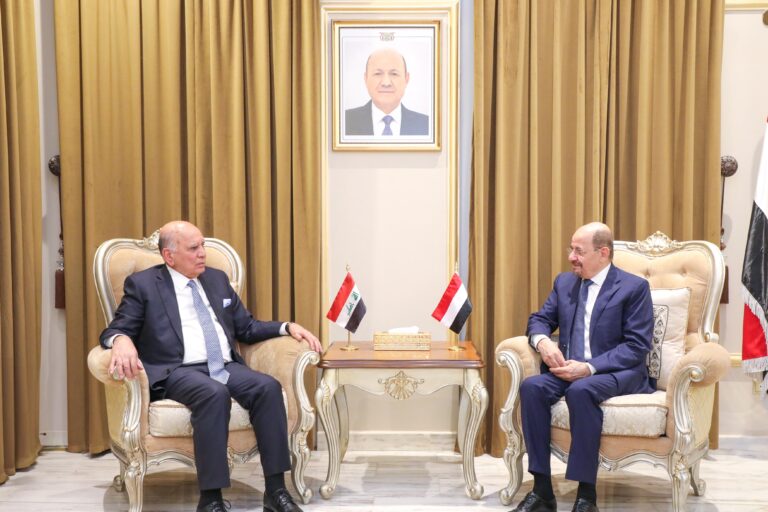أحيانا ينتابنا شعورٌ بالضجر ونحن نشاهد ينبوعًا تدفق فملأ الشارع بالقذارة والريحة العفنة وتوسخت ملابس المارة ومركباتهم وصاروا يتأففون ويكيلون التهم والسباب حتى تأتي مركبة النينجا ـ كما يحلو لصديقي أن يسمّيها ـ ويخرج منها الأبطال، ويعملوا بكل جد وتفاني ويفكوا الانسداد، والذي غالبًا ما يكون بسبب رمي الحفاظات في الصرف الصحي، أو تجمد الدهون والشحوم، إلا أنه أحيانًا يستعصي الأمر بكافة الوسائل فيتطلب (عوصه)، وليس بمقدور أي شخص السباحة أو الغوص في خزانات الصرف الصحي، فبمجرد أن تدلي رأسك حتى يظهر شريط الذكريات واضحًا أمام عينيك.
لقد رحل أيوب وترك خلفه ذكريات لا تنسى، فقد فرج كمن كربة، وأعاد لبعض الأماكن والممرات طاهرتها، بعد أن عبثت بها النجاسة.
نعم، رحل أيوب بعد نخر المرض في بدنه بسبب مياه ومخلفات الصرف الصحي التي كانت روتينا يوميًا في أيام الدوام أو الإجازات، صابرًا متعديًا نفعه للآخرين، فتجده إمّا ممسكًا بعُدّة فك الإنسداد أو غائصًا في إحدى غرف التفتيش أو الخزانات الكبيرة دون أدنى وسائل السلامة وأدواتها عدا سروالًا يغطي عورته.
نحن لم نفقد أيوب! فقد فقدنا قبله عبدالوهاب وسعيد باسلم وغيرهم، الذين رحلوا مبكرًا دون أن تحيطهم الرعاية الطبية الدورية ويستمتعوا بالأكل الصحي ويرتدو معدات السلامة المهنية _وهو أقل مايطلبونه_ حتى أنهكهم المرض وفاجأنا رحيلهم المبكر.
أما عن فقيدنا فهو آخرهم وأمهرهم في السنوات الأخيرة، وكان متنقلا بين العمل العام الخاص متجولًا بتكتوكه الصغير ذا الأضواء الزاهية، وذلك لتدني الأجرة التعاقدية وضعف وغياب الحوافز والإمتيازات، التي يختص بها البعض أضعافًا.