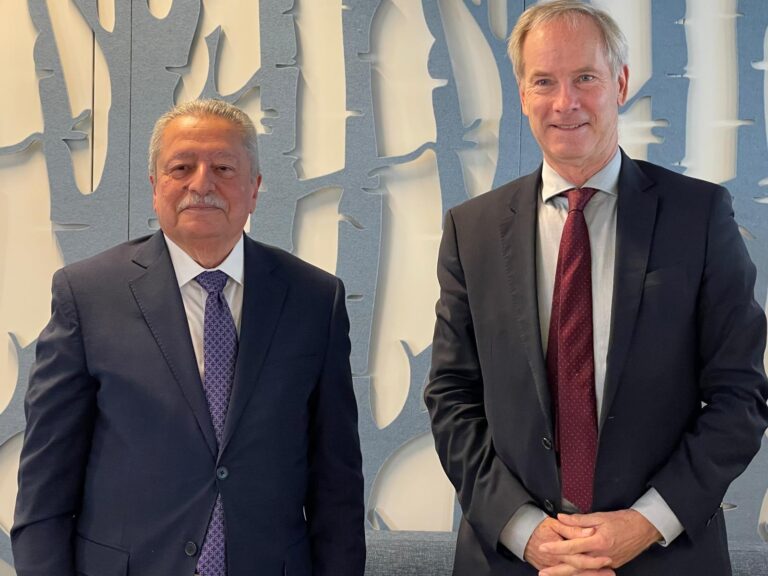في مثل هذا اليوم من عام 1990، استيقظ اليمنيون على حلمٍ لطالما تمنّوه، فتوحّدت الجغرافيا، وتعانقت الرايات، ورفرفت الأمال في صدور أجيالٍ أنهكها الانقسام. كان الثاني والعشرون من مايو وعدًا بوطنٍ جديد، يسوده العدل والمواطنة والتنمية. غير أن ذلك الوعد، بعد خمسة وثلاثين عامًا، لم يُنجَز كما ينبغي.
لا يمكننا في هذه اللحظة المفصلية أن نتحدث عن الوحدة اليمنية بمنطق التغنّي المجرد، ولا بلغة التمجيد العاطفي، وكأنّ شيئًا لم يكن. لأن من الإنصاف أن نُصغي – بكل صدق – لا أن نصمّ آذاننا عن أصواتٍ يمنية مُخلصة تنظر اليوم إلى تلك التجربة من زاوية الألم، لا الأمل. أصواتٌ ترى أن ما كان ينبغي أن يكون جسرًا للكرامة، تحول إلى حائط من الخذلان، وأن الحلم الذي وحّد الشعب، فرّقهم بواقعٍ لم يُحقق العدالة ولا الشراكة.
لكن لِنكُن منصفين: إن المشكلة لم تكن على الإطلاق في الفكرة والقيمة النبيلة، بل كانت في التطبيق والممارسة. ليست الوحدة بذاتها ما جَرَح النفوس، بل السياسات التي أُديرت بها، والممارسات التي قزّمت المعنى النبيل للوحدة، وجعلتها تُقاس بكمّ السلطة المركزية وبمقدار الغنيمة والفيد لطرفٍ على حساب آخر، لا بمدى شعور المواطن بكرامته وانتمائه.
لقد رافقت مسيرة الوحدة منذ بداياتها أخطاءٌ جسيمة، في تقاسم السلطة والثروة، وفي فرض المركزية، وفي تجاهل الخصوصيات والهويّات المحلية، ما زرع الشك بدل الثقة، والحسرة بدل الانتماء. وهذه الأخطاء لم تُجهض فقط مشروعًا وطنيًا عظيمًا، بل دفعت بكثير من أبناء الوطن – ممن كانوا ذات يوم من أكثر المنادين بالوحدة بل وأشدّ المدافعين عنها– إلى أن يصبحوا اليوم في خانة المعارضين لها، لا كرهاً لفكرتها، بل احتجاجًا على ما أصابها من تشوه وما أصابهم من ظلمٍ وحَيف.
ورغم كل ما حدث، لا تزال هناك فرصة، بل مسؤولية أخلاقية ووطنية، لجبر الخواطر قبل جبر النصوص. لأن الأوطان لا تُبنى بالتجاهل، بل بالاعتراف، ولا تُرمم بالجفاء، بل بالمصالحة. ونحن اليوم بحاجة إلى قراراتٍ وطنيّةٍ شجاعة تعترف بالضرر الذي لحق بمناطق بأكملها، وتعيد الاعتبار للكرامة المجروحة، وتمنح المواطنين جميعًا – في الجنوب كما في الشمال، في الأطراف كما في المركز – شعورًا بالمساواة والإنصاف.
إننا بحاجة إلى إعادة تعريف الوحدة من جديد، ليس كوضع إداري أو قرار سياسي، بل كمشروعٍ وطني جامع. وحدةُ قلوبٍ قبل أن تكون وحدة خرائط، وحدةُ احترامٍ للآخر لا إقصاء له، وحدةُ مواطنة متساوية لا طبقية مناطقية، وحدةُ توزيعٍ عادل للثروة والفرص، وحدةُ دولةٍ تُنصف لا تُهمّش، تُداوي لا تُقصي.
لقد آن الأوان أن نُحيي الوحدة لا كشعارٍ جامد، بل كعقدٍ اجتماعيٍ جديد يُعيد الثقة، ويضمن الشراكة، ويحتضن التعدّد، ويقدّم الاعتذار حيث يلزم، ويبدأ من مراجعة صادقة وشجاعة لمسيرة مضطربة.
الوطن ليس حدودًا نرسمها على الورق، بل هو ذلك الإحساس العميق بأنّ لك فيه مكانًا محفوظًا، وكرامةً مصانة، وعدالةً قائمة. ومتى ما غاب هذا الإحساس، صار كل شعار – مهما علا – فارغًا من روحه.
في الذكرى الخامسة والثلاثين للوحدة، لا نطلب من المتألمين أن ينسوا، ولا من المجروحين أن يتجاهلوا ألمهم وجراحهم، بل ندعوهم أن نتشارك جميعًا ذلك الألم، ونتحمّل جميعًا ذاك الجرح،وفي ذات الوقت نتشارك معًا حُلم التصحيح، وأن يمنحوا الوطن فرصة جديدة، لكن على أسسٍ جديدة. أسسٌ لا تنكر الجراح بل تداويها، ولا تتهرب من المسؤولية بل تواجهها بشجاعةٍ ومسؤولية، وتبني مستقبلًا للجميع قائمًا على الصراحة والشفافية والعدل.
إنّنا اليوم جميعًا كيمنيين شمالًا وجنوبًا، شرقًا وغربًا، نمرّ بمحطّاتٍ فارقةٍ نحياها في حاضرنا اليوم، وسيكون لها بالغ الأثر على مستقبلنا ومستقبلِ أجيالنا غدًا، في عالمٍ متلاطم الأمواج، لا مكان فيه لأنصاف الأقوياء، فما بالك بالضعفاء، أرهق أقوى التكتلات والتجمعّات الدولية، فما بالك بدولةٍ صغيرةٍ يتناهشها التمزّق والاحتراب. فلنكن عقلاء وشجعانًا ومسؤولين في ذات الوقت، ونتوقف في هذه اللحظة لنرى الركامَ من حولنا، وصرخات الجوعى والمُنهكين تضجّ بها شوارعنا وبيوتنا، والدخان في أجواءنا، فلا نكاد نرى من خلاله فُرجةً للخلاص، غير أنّ نضع أيادينا معًا، وتلتقي قلوبنا وجهودنا في سبيل الخلاص مما نحن فيه، وبعدها يبقى الحوار – لا البنادق – سبيلنا وأداتنا لنرسم بأفكارنا وأيدينا مستقبلنا كما نريد، وكما نرتضيه لأجيالنا من بعدنا.
ولعل أفضل احتفاء بهذه الذكرى أن نقول جميعاً: نريد وحدةً لا تُفرض، بل تُفهم. لا تُجمّل، بل تُصحّح. لا تجرح، بل تُجبر. ونريدُ وطنًا يتّسعُ للجميع، فهل نملك شجاعةَ البداية من هنا؟